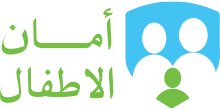«ستخرجين وحدك؛ لأنَّ الدُّكان قريبةٌ، ولا سيّارات تمُرُّ في الحَيّ».
آيات عبد المنعم/ متخصصة تربوية
بينما مفهوم الإعاقة قطع شوطًا إنسانيًا، عبر تطور الزمن، ليخرج من المنظور الضيق الذي يراها خللًا يحتاج إلى إصلاح، ركز على أبعاد وجودية واجتماعية وأخلاقية.
قديمًا كانت هناك نظرة إقصائية جسّدها الفلاسفة الذين تربعوا على عرشها، وما يزال إرثهم الفكري يحظى بالاهتمام والدراسة في المحافل العلمية، أمثال أفلاطون الذي دعى بضرورة التخلص من البشر الذين أصيبوا بالإعاقة الجسدية كونهم يشكلون عبًا في جمهوريتهِ الفاضلة، كما لم يختلف أرسطو عن أستاذهِ في هذا الموقف، ففي كتابهِ "السياسة" تحدث عن المدينة الفاضلة بأنَّها مدينة الأقوياء الأصحاء فقط!
رأى أرسطو أنَّه حين يصل الأطفال إلى سن التربية، يجب تصنيفهم، بين الأطفال الذين يمكن للدولة أن تشرف على تربيتهم، وأولئك الذين لا يصح الاهتمام بهم، وهم الأطفال المعاقون. يقول: "يحسن أن يحظر بقانون أية عناية بأولئك الذين يولدون مشوهي الخِلقة([1]).
لم يختلف بعض فلاسفة عصر النهضة في الغرب، والذين اهتموا بالإنسان والمساواة والمواطنة بين الجميع، أصحاء ومرضى، فقد دعا فلاسفة عصر التنوير إلى العدالة والتعاطف البشري، فتمخض ما عُرف في ما بعد باسم "وثائق حقوق الإنسان"؛ لكن كان هناك مجموعة من الفلاسفة العنصريين الذين آمنوا بضرورة التمييز بين البشر، على أساس القوة والضعف، فهم من أنصار فلسفة "السوبرمان" أي الإنسان الأعلى؛ وعلى رأسهم الفيلسوف الألماني الشهير نيتشه.
هذه الآراء قد تكون صادمة للبعض، فهي خارج إطارها الزمني الموضوعي حين كانت تُبنى فيه الإمبراطوريات على عوامل القوة وسواعد الرجال، فحتى النساء لم يحظينّ عمومًا بالتقدير إلا لإنجاب الأطفال، وحتمًا هذا لا يُسوّغ نظرة الإزدراء لأي فئة، لكن يمنحنا محاولة للفهم. الآن، في الجتمعات المعاصرة - بحمد الله- تغيرت وجهة النظر تلك؛ ونشأت مصطلحات تُطلق على من تعرض لأي نوع من الإعاقة الجسدية، مثل "ذوي الاحتياجات الخاصة" أو "أصحاب الهمم". برأيي؛ أنّنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة نتيجة جهد فكري مارسهُ العديد من المفكرين والأدباء الذين هضموا العصارة الروحيّة للشرائع السماوية التي تُقدر جوهر الإنسان بمعزل عن لونه وشكله وعرقه، وقرأوا التراث الإنساني بعين ناقدة وفاحصة أسهمت في تشكيل وعي جديد.
في هذا السياق، تبرز أهمية قصة الكاتبة سنا الحاج ([2]) "لا شَيء يُعيقُني"، لا سيما أنَّ النص ينتمي إلى أدب الأطفال. هذه الشريحة التي تحمل في بذورها آفاق المستقبل. في منتصف القرن العشرين تقريبا؛ تححقت مكتسبات إيجابية وصلنا إليها في تعريفنا للإعاقة، وتعديل النواقص التي تشوب تصوراتنا نحوهم، وعلاقتنا مع أنفسنا، فهم جزءٌ منا لا يتجزء، هم ليسوا آخر مختلف عنا في الإنسانية، وليسوا عبًا، بل منهم ثلة فعالة حظيت بالعناية، وأصبحت تُسهم في بناء الإنسان والأوطان.
قبل عرض القصة، وفي سياق الموضوع؛ استوقفني حديث الإعلامي "إلياس طوق"، في برنامج "Table 3 Show"([3]) الذي يقدمه مع الإعلامية "إليسا حريق"، حين عبر "إلياس" عن فكرة أصحاب الهمم، قائلًا: «كنتُ أعتقد أن كلمة "أصحاب الهمم" تُعطي ضوءًا وثقلًا للإعاقة، لكن ما يهمني أن أكون إنسانًا أولًا، لأنَّ الخطأ عند الناس يكمن في إلغاء الإنسانية والتركيز على الإعاقة، حتى لو كانت "أصحاب الهمم" ستمنح للإعاقة ثوبًا جميلًا". يعبر إلياس، بكلِّ شفافية، بأنَّ ما جعله يتصالح مع ذاتِه اكتشافه أنَّ إنسانيتهِ أهم من إعاقته، والعبارة الأحبّ إلى قلبه أشخاص عندهم إعاقة، كي يحافظ على هويته الإنسانية، ويحبّ أنَّ ينظر الناس إلى إنسانيته أولًا، فإذا كان يستحق أن يكون من أصحاب الهمم فليمنحوا له هذا التوصف، وإذا كان لا يستحق فلا مسوّغ لذلك؛ لأن هذا يضيف ثقلًا على إعاقته. كما ليس من المعقول أنّ كل من لديه إعاقة صار تلقائيًا من أصحاب الهمم، ويجب على الآخرين التعامل معهم على أساس إنسانيتهم بمعزل عن إعاقتهم». أتعجب لمَ المحطات الإعلامية لا تجعل برنامجاً ثابتاً توظف تلك القدرات الفذة من أصحاب الهمم، ولماذا لا تكون مشاركتهم في الإعلام والمسلسلات الدرامية جزءًا مهمًا،
يبدو أنّ الحديث، في عالم الكبار يتسع ولا حصر لدوائر التأمل فيه. قد يكون أكثر اتساعًا في عالم الصغار حين يحمل الكاتب تلك القضية على عاتقه. الكاتبة الدكتورة سنا الحاج -رحمها الله- لم تكن تسرد قصصًا للأطفال عن الإعاقة من وحي خيالها الحُرّ، بل صاغت تلك القصص من عرقِ عناء فيروس شلل الأطفال الذي أصابها في الصغر، وصف لها الطبيب جهازي تقويم من حديد تنتعلهما في الطرفين السفليين، عبرت عن ذلك بجملة في أحد مقالاتها: "كأنَّ قدمي عصفوران داخل قفص"!.
اعتقد أنَّ الكاتبة قد تحررت في هذه القصة، وأطلقت جناحي العصفورين لترسم لنا ملامح من روحها الجميلة المقاتلة، فكل من عرِف سنا، يُدرك أنَّ نور الشّمس محالٌ أن يُعتقل بسورِ عكازتين.
تأمل بين دفتي قصة "لا شَيء يُعيقُني"
إن وقعتْ بينَ يديكَ قصة "لا شَيء يُعيقُني"، وتأملتَ الغلاف الأمامي، ستجدُ لوحةً فنيَّة زاهية الألوان، فيها مجموعة من الأطفال. تتصدرُ اللوحة طفلةٌ صغيرةٌ تقفُ على الشرفةِ ضاحكةً وذراعيها مبسوطتان، وكأنَّهما يُنافسانِ أجنحةَ العصافير، ويُحلقان بفرحٍ وحريّة، وسط كلِّ هذا المشهد البهيج تذوب العُكّازة الزهريّة اللون ([4])، بالكاد تلمحُها عينُ القارئ، وربَّما الذي يساعده فيٰ ذلك العنوان والغلاف الخلفي للقصة، والمدون في أعلاه الموضوع: «الاحتياجات الإضافية، المغامرة، تقبُّل الآخر».
تبرزُ أهمية القصة من القضية المحوريّة التي تبنتها الكاتبة الحاج، فقد حاولت في سبعةِ عشر صفحة، إتاحة فرصة للطفل كي يتجول في عالم ذوي الاحتياجات الخاصة، ليتعرّف بعض تفاصيله وتحدياته، سواءً أكان هو الذي يعيش فيه أو من يُصادفهم في حياتِه، من خلال بطلة القصة الطفلة الجميلة "سنا" التي شاركتنا تحديّين.
١- التحدي الأوّل ودور الأب المسؤول
لم تكن "سنا" بطلة القصة وحدها، لقد شاركها البطولة والدها الذي خلق تحديًّا لها، بحس الأبّوة المسؤول، جعلها تعتمد على نفسها لشراء المُثلّجات من الدكانة القريبة، ولم ينظر إلى عُكّازتيها نظرةً قاصرة، تَحدُّ من إمكاناتها.
- «لكِنَّهُ لم يُسارع إلى الدُّكان ليشتري لي ما أريد كعادته، بل مدَّ يده إلى جيبه وأعطاني مالًا وقال لي مُشجِّعًا: «اليوم، ستذهبين أنتِ إلى دكّانِ أبي جميل، وستشْترين المُثلَّجاتِ بنفسكِ".
- كيف أخرجُ وحدي؟!
- «ستخرجين وحدك؛ لأنَّ الدُّكان قريبةٌ، ولا سيّارات تمُرُّ في الحَيّ».([5])
كان هذا أوّل تحدي لـ "سنا"؛ وهي تواجه العالم الخارجي وحدها، فعندما خرجت وجدت عددًا من أولاد الحيّ يلعبون، وبمجرد رؤيتها توقفوا عن اللَّعبِ وتجمعوا حولها، ونظروا إليها نظرة استهجان، كأنَّها كائنٌ آتٍ من الفضاء. تصفُ لنا "سنا" مشاعر الخوف التي انتابتها، وتسردُ بالتفصيل كيفَ أنَّ أحدهم ضَحِكَ، وهمَّ آخرٌ لأخذِ إحدى عُكازَتيّها، ولولا صُراخ "أبو جميل" صاحب الدكّان عليهم لما انصرفوا وابتعدوا عنها.
عندما عادت إلى البيتِ خائفةً باكية، برز دور الأبِ من جديد، والذي أصغى إليها، واحتضنها، وشجعها على الذهاب مرّةً أخرى، ونصحها بأنَّ إذا أحدُهُم اقتربَ منكِ بقصدِ إيذائِكِ، هدِّديه بِعكّازتك.
بالفعل قامت "سنا" بمسحِ دموعها، وكبحِ خوفها، وسيطرت على دقاتِ قلبها المُتسارعة، وتشجَّعت بكلام أبيها، ووصلت إلى الدكّان، وطلبت من العمِّ "أبي جميل" المثلجات، والذي قال لها وهو يعطيها إياها، «أنـا فخـورٌ بِـكِ!»([6]). هنا لا بُدَّ من الإشارة إلى دور المحيط الخارجي في دعم السلوك الإيجابي للطفل المعوق، فلا نبخل بكلمات الثَّناء على ما قام بِه؛ لأنَّ ذلك يُعزّز السلوك الإيجابي، وذاكرته لا تنسىٰ تلكَ الكلمات الطيبة التي تظلّ كالوشمِ تُزين روحه، وترافقه طوال سنوات حياته.
٢- التحدي الثاني وابتكار الحل
في اليوم الذي انتصرت فيه الطفلة "سنا"، وكسبت التحدي الأوّل بشرائها المُثلّجات، وكسرت حاجز الخوف، بدأ الأولاد يقتربون منها ليتعرّفوها، فسألوها عن سبب مشيها بعكازتين، فأجابتهم لأنَّ قدميها نحيلتان. وسألوها أن تلعبَ معهم، فرحت بذلك للغاية لكنها اعتذرت إذ يجب أن تعود إلى البيت، وستعلب معهم غدًا.
هذه التفاتة تربوية من الكاتبة، كي ينتبه الطفل أنَّ عليه أن يلتزم بمواعيد العودة إلى البيت، وطلب الاستئذان من الأهل إن أراد اللعب مع رفاقه.
في اليوم التالي؛ وجدت الأطفال يلعبون لُعبة "الحجر والمربَّعات"، تعلمت "سنا" من صديقها "مجد" كيف تلعبها، وبعد ذلك صارت تُجيد رمي الحجر إلى المربع المُحدَّد، ثم تقفز على قدم واحد من مربعٍ إلى آخر، وتدفع الحجر بقدمها إلى المربع المجاور، وتحمل العُكّازتين بيدٍ واحدة، وترمي الحجر باليد الأخرى، ثم تقف على قدم واحدة وتقفز بمساعدة العُكّازتين. غدت ماهرة؛ وتغلبت على الأطفال جميعًا الذين نظروا إليها بدهشةٍ بالغة، وفي النهاية صفقوا لها.
لكن تلك الفرحة لم تكتمل، إذ ظهر لها تحدٍ ثانٍ، في أحد المرات، وفي أثناء اندماجها في اللعبِ، مرّ والدها عائدًا من العمل، ورآها تلعبُ في البداية ابتسم، لكن سرعان ما تلاشت ابتسامته، وطلب منها الرجوعَ إلى البيت.
حينها؛ وصفت الكاتبة شعور بطلتها الصغيرة "سنا" كيف أنَّها أسرعت في تلبية طلب أبيها بالعودة إلى البيت، وخوفها من غضبه. لم أستطع تجاوز تلك السطور، وأنا أسبر القيم التربوية في هذه القصة، لأنَّنا بتنا نعاني في واقعنا المعاصر الاجتماعي زعزعة صورتي الأب والأم اللتين يقدمها كثير من الأهالي لأبنائهم، جراء عدم إدراكهم للمعنى الحقيقي للتربية الإيجابية الحديثة، فلا يستطيعون تحقيق التوازن بين اللين والحزم والحفاظ على مقام الوالدين ومكانتهما في الاحترام والهيبة، لدرجة أنّنا نرى في بعض الحالات انقلاب الموازين، فهناك بعض الآباء والأمهات يخافون من أبنائهم لا العكس، ولا يقدرون ممارسة دورهم التربوي القيادي.
لذلك؛ راق لي التعبير عن ذاك الخوف الطبيعي من بطلة القصة "سنا" وحرصها على ألّا يغضب أبوها، ومحاولة فهم سبب انزعاجهِ، حين طلب منها خلع حذائها الطبي، وجاء بأدوات الصِّباغة ليعيد صبغ الحِذاء وتلميعهِ من جديد، وقال بأسًى: "لا نستطيع شراء حذاءٍ جديدٍ كل يوم يا حبيبتي. إنَّهُ حذاء غالي الثمن، وصناعتُهُ صعبة. إلعبي بألعاب أخرى غير لعبة الحجر والمربَّعات. يجب أن يبقى هذا الحذاء صالحًا أطولَ مُدَّة ممكنة"([7]).
الكاتبة سنا الحاج، لم تكن تشرح للطفل تفاصيل الحذاء الطبي فحسب كونه حالًا خاصّة، علّمت الطفل احترام قيمة الأشياء الماديّة والحفاظ عليها، فلا يفرط بأغراضه الشخصيّة حتى عندما يلعب.
عمومًا؛ هذا التحدي جعل الطفلة "سنا" تُفكرُ على مدار يومين، وهي تراقبُ رفاقها يلعبون في الخارج، ما حفزها على فكرةٍ هرولت لتطبيقها، فقامت بخلع الحذاء الجلديّ الأسود الضخم من قدمها اليسرى، واستبدلتهُ بنعلٍ قديم تظهرُ من خلاله أصابع القدم، وأبقيت الجهاز الطبي الموصول بحذاءٍ من الجلد في قدمها اليُمنى، وعادت إلى اللَّعبِ بفرحٍ كبير، لتنتهي القصة بجملة.. "ولم يعد شيءٌ يُعيقُني!"([8]).
رأي النقاد
يرى بعض النقاد أنَّ الأسلوب المباشر قد طغى على القصة، قد يكون رأيهم هذا سليمًا، لكني لا أراه مخلًّا في جمالية القصة؛ لا سيما وهي تُصنف ضمن الأدب الواقعي، وتُشكل خريطة معرفيّة للأهل والمربين، ترسم بين سطورها معالم الطريق سواءً لمن يهتم منهم بطفل من أصحاب الهمم، أم لكيفية التعامل معهم في محيطنا المُجتمعي.
جدير بالذكر أنَّ الطالبة الجزائرية "شاشة الزوّاي"، من جامعة غرداية الجزائريّة، أجرت دراسة الماجستير على هذه القصة، والتي حملت عنوان "التعاضد التأويلي في قصة لا شيء يعيقني"([9])، وهي مقاربة في ضوء نظرية التلقي. دراسة ميدانية على عينة من أطفال مرحلة الطفولة المتأخرة. نالت الطالبة درجة التفوق والامتياز في رسالتها الماجستير في الأدب العربي الحديث والمعاصر.
لا بدَّ من الإشارة بأنَّ "لا شيء يعيقني" هي قصة من مجموعة قصص واقعية لأدب الأطفال للكاتبة الدكتورة سنا الحاج صدرت، في العام 2017 عن دار أصالة، تروي يوميات وتفاصيل حياتية لأطفال ذووي الاحتياجات الخاصة. على سبيل المثال هناك قصة أخرى بعنوان "عُكازة العيد".
تميزت معظم الرسومات في القصص بألوانها الزاهية والابتسامات التي تعلو وجوه الأطفال، بريشة الرسام "بي بولت دشني"، عرضت في معرض بيروت العربي، وفي العديد من معارض الدول العربية آخرها في معرض الدمام في المملكة العربية السعودية حيث كان لصحيفة "الشرق الأوسط" وصف للقصة التي نالت إعجاب القيمين على المعرض المذكور بالقول: "لا شيء يعيق الثقافة".
ختامًا..
حين يرحل الكاتب عن عالمنا؛ تظل كلماته تُحلقُ في تلافيف عقول الصغار، والنص الجيد يبدأ تأثيرهُ بعد نقطة الخاتمة؛ أكتبُ ذلك وقد حدث معي بالفعل من وحي قرائتي لهذه القصة لابنتي أختي الصغيرتين اللتين تأثرتا بها، وبعد أيام من قرائتها، ابنتها الكُبرى "فاطمة" صنعت علمَ فلسطين من معجون طين الصلصال وألصقتهُ على ورقة، ورسمت بقربه فراشة تطير، وبجانبها عبارة: "لا شيء يُعيقني".
لترقد روحك في عليائها بسلامٍ ومحبّة دكتورتنا وصديقتي العزيزة سنا الحاج، وستظلُّ مؤلفاتك وقصصك جنتنا الصُغرى التي تُؤتي أُكُلَها كلَّ حين.
المراجع والمصادر
[1]- صلاح حسن رشيد، لماذا عادى الفلاسفة المعاقين وأصحاب العاهات؟، المجلة العربية، يناير، 2006، بالإمكان الرجوع للمصدر في كتاب الجمهورية الفاضلة لأفلاطون، وكتاب الساسية لأرسطو.
[2]- سنا أحمد الحاج، مواليد1965، حائزة على شهادة الدكتوراة في الفلسفة ومقارنة الأديان من الجامعة العالمية للعلوم الاسلامية – لندن. شغلت منصب رئيسة دائرة الدراسات والبحوث في وزارة الاعلام، كانت عضوًا في هيئة التحرير في مجلة ” دراسات لبنانية” ولها العديد من المؤلفات والأبحاث في موضوعات فكرية وثفافية شتى، بالإضافة إلى إبداعاتها في مجال قصص الأطفال، انتقلت إلى رحمة الله تعالى، في في ١١ تموز في العام 2024.
[3] - البرنامج عبارة عن طاولة حوار يديره إعلاميان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهما "إلياس طوق"و "إليسا حريق"، والحوار ذُكر في حلقة استضافة الإعلامي ريكاردو كرم.
[4]- رسم: بي بوليت دشني.
[5]- سنا الحاج، قصة: "لا شيء يعقيني"، رسم:بي بوليت دشني، دار أصالة، ط:1، 2017، ص:4/5.
[6]- المصدر السابق: ص 9.
[7]- المصدر السابق: ص:15.
[8]- المصدر السابق: ص:17.
[9]- راجع موقع وزارة الإعلام اللبنانيّة، يوليو، 2018، وأيضًا موقع مجلة غيمة، الكاتبة شاشة الزواي، عنوان المقال: مراجعة نقديّة لقصة "لا شيء يعيقني"، 14/10/2021.
مواضيع مرتبطة
القراءة... آخر خطوط الدفاع أمام تعفّن الدماغ
تعزز القدرة الفردية على التحكم في الموارد الذهنية والبيئة التي تشكّلها
كيف تصنع قصص المساء انسجاما بين دماغ الطفل ووالديه؟
القراءة المشتركة تعزز الارتباط العاطفي وتدعم نمو الطفل اللغوي والمعرفي